فقه الاستجابة في زمن التحولات (2)
دور الفقيه.. بين النظرية والواقع
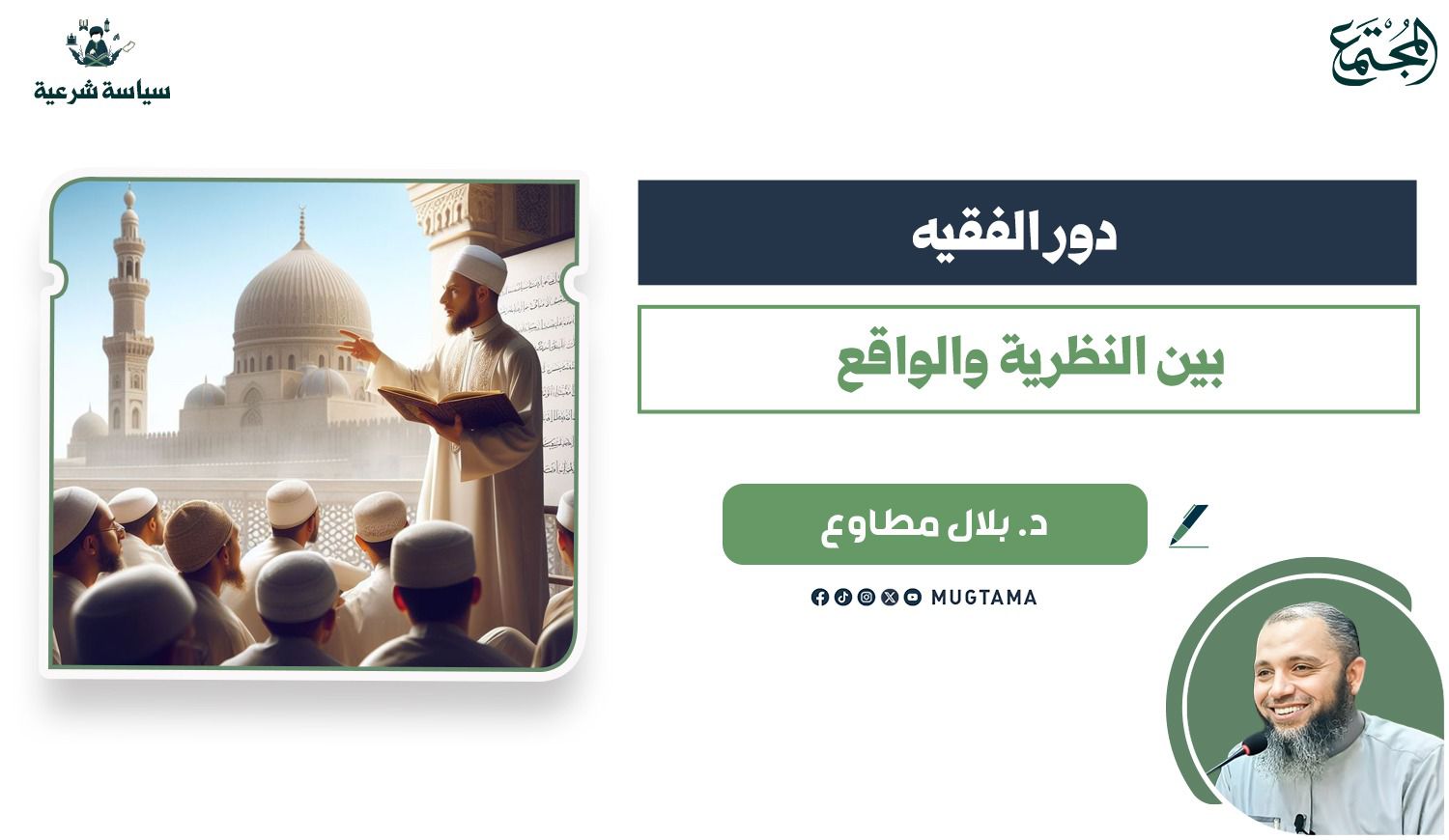
أولًا: مركزية السلطة العلمية في التصور السياسي الإسلامي:
تتأسَّس مركزية
السلطة العلمية في الفكر السياسي الإسلامي على أنَّ قادة الرأي في المجتمع المسلم
هم الأمراء والعلماء، إذ يقوم المجتمع المسلم على سلطتين؛ السلطة السياسية ممثلة
بالأمراء، والسلطة العلمية ممثلة بالعلماء.
فالإمام مقيَّد
بالشريعة، لكون الإمامة تنفيذية وهي محلّ السيادة، لكنها ليست مصدر الشرعية؛ إذ إن
مصدر الشرعية الشريعةُ والقائمون عليها من الفقهاء.
وتتجلى أهمية
السلطة العلمية في التصور السياسي الإسلامي من خلال الوظائف المنوطة بأصحابها
(العلماء) والموكولة إليهم؛ وهي وظائف تبدأ باختيار من يتولّى أمر الأمة، وتمرّ
بضرورة استشارتهم، وإن كان الإمام بالغًا رتبة الاجتهاد، وسلطانهم في عزله عند
اقتضاء الحال، وتنتهي بكونهم المرجع الأول والأخير عند شغور الزمان عن الإمام
(حالة الفراغ السياسي).
يقرّر الجويني
أن العلماء هم المرجع إذا خلا الزمان من قائمٍ بأمر المسلمين؛ أي إذا مرّت دولة
الإسلام بفترة فراغ سياسي، ويؤكد فقه هذه المسألة في مواضع من الغياثي، من ذلك
قوله: «فَإِذَا شَغَرَ الزَّمَانُ عَنِ الْإِمَامِ وَخَلَا عَنْ سُلْطَانٍ ذِي
نَجْدَةٍ وَكِفَايَةٍ وَدِرَايَةٍ، فَالْأُمُورُ مَوْكُولَةٌ إِلَى الْعُلَمَاءِ،
وَحَقٌّ عَلَى الْخَلَائِقِ عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى
عُلَمَائِهِمْ، وَيُصْدِرُوا فِي جَمِيعِ قَضَايَا الْوِلَايَاتِ عَنْ رَأْيِهِمْ،
فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ هُدُوا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَصَارَ
عُلَمَاءُ الْبِلَادِ وُلَاةَ الْعِبَادِ» (الغياثي، ص 469).
غير أن هذا
الاستحقاق النظري الذي يحظى به العلماء لا يعني بالضرورة صيرورتهم ولاةَ الأمر
ومرجعَ المسلمين عمليًّا عند اقتضاء الحال؛ ذلك أن السلطة كالطبيعة تكره الفراغ
(كما يقول أرسطو)، يملؤها أكثر الناس استعدادًا، وهذا يعني أن جماعة العلماء لا بد
أن تكون مستعدة لملء الفراغ، وتمتلك الأدوات التي تؤهلها لذلك، وإلا كانت سهامًا
في كنانات غيرها، وموظَّفة ضمن أجندات الفاعلين الجُدد.
بعبارة أخرى، لا
بد أن يمتلك الفقيه حضورًا وتأثيرًا في المحيطين السياسي والاجتماعي، ليكون قادرًا
على النهوض بأعباء هذه السلطة (السلطة العلمية) على الوجه المنشود.
ويتجلّى الفقه
الحي عند الجويني في إدراك هذه المسألة، إذ لم يشترط لصحة عقد العاقد للإمامة أن
يكون بالغًا مبلغ المجتهدين، بل يكفي بحسب تعبيره: «أَنْ يَكُونَ الْمُبَايِعُ
مِمَّنْ يُفِيدُ مُبَايَعَتُهُ مُنَّةً (بالضم، أي: قوة) وَاقْتِهَارًا» (الغياثي،
ص 252).
وفي ختام حديثه
عن استحقاق العلماء للولاية عند شغور الزمان عن الأئمة، أفاد أن العالم إن لم يكن
ذا كفايةٍ وهدايةٍ إلى عظام الأمور، فإن طبيعة الأشياء -أو منطق السلطة- تقتضي ألا
يكون هو صاحب الأمر، وأنه في أحسن الأحوال يكون وزيرًا ومستشارًا لمن آل إليه
الحكم، والذي يتحتّم عليه ألا يبتّ أمرًا دون مراجعة العلماء. (الغياثي، ص
470-471).
والمقصود أن
السلطة العلمية لا تُسْتَمَدُّ من العلم فحسب؛ فكفاية العلم بمجرّدها «مِنْ غَيْرِ
اقْتِدَارٍ وَاسْتِمْكَانٍ لَا أَثَرَ لَهَا فِي إِقَامَةِ أَحْكَامِ الْإِسْلَام»،
على حد تعبير الجويني. (الغياثي، ص 466).
ثانيًا: مظلومية الفقيه بين الدعوى والواقع:
يشكو علماء
الشريعة تهميشهم من قِبَل السياسيين، حتى لو كان هؤلاء الساسة إسلاميين أو وطنيين،
وفي الواقع، فإن جزءًا من المسؤولية تقع على عاتق الفقيه نفسه؛ لأنه بتأخره عن
مجاراة الواقع سمح لغيره أن يتجاوزه، بل يتجاوز الشريعة التي يحملها؛ الأمر الذي
لا يجني على مكانة الفقيه نفسه، بل يجني على الشريعة التي يحملها وينادي بتطبيقها،
حيث يظهرها بمظهر الضعيف غير القادر على مواكبة التحديات وتلبية احتياجات الواقع.
وهذا داء قديم؛
تحدث عنه أمثال ابن القيم، والحجوي الفاسي، من خلال نقد العقل الفقهي، فقد رأى الفاسي
أن جمود العقل الفقهي على أقوال الفقهاء السابقين في ظل عالم متغير متطوّر «لا
فائدة منه سوى العزلة، وسقوط هيبة الإسلام، ونبذ أحكامه كليًّا» (الفكر السامي، ج
2، ص 478)، بل رأى أن الإصرار على ذلك فيه جناية على الشريعة، لما يترتب عليه من
مفاسد عظيمة، من مثل: دفع الناس إلى القوانين الوضعية، ونبذ الشريعة، وسوء ظنهم
فيها مع أنه لا ذنب على الشريعة التي فتحت باب الاجتهاد، وباب المصالح المرسلة
ونحوها، وإنما الذنب على بعض من العلماء المقلدين الجامدين المتعصبين. (الفكر
السامي، ج 2، ص481).
ثالثًا: في أسباب تأخر الفقيه عن الواقع:
لكن، لماذا
يتأخّر الفقيه؟ ولماذا يبدو الواقع أسرع منه، خصوصًا في قضايا الشأن العام؟ يعود
ذلك إلى أسباب مركَّبة، بعضها ذاتي والآخر خارجي، ويمكن الإجابة عن هذا السؤال من
خلال النقاط التالية:
1- خروج الفقيه من التأثير في المجال العام:
مبكرًا في
التاريخ الإسلامي، وقع الصدام بين السلطتين السياسية والعلمية، خاصة إذا كان ممثلو
السلطة العلمية أئمة مجتهدين في الشريعة، وانظر مثلًا ما حصل للأئمة الأربعة (أئمة
السلطة العلمية في الإسلام) من ابتلاءٍ شديد من قِبَل السلطة السياسية.
هذا الصدام بين
السلطتين ألقى بظلالٍ سلبية على تأثير السلطة العلمية سياسيًّا، التي أضحت تمارس
دورها خارج أسوار قصور السلاطين عبر الفعل المجتمعي.
على إثر زوال
آخر سلطانٍ سياسي للمسلمين، وإقصاء الشريعة عن الشأن العام إلّا في مجالات محدودة،
تقلّص دور الفقيه في المجال العام كثيرًا، وفي ظل نموذج الدولة القومية الحديثة
التي تحتكر أدوات العنف والسيطرة تقلَّص دور الفقيه إلى أبعد مدى.
هذا الأمر ألقى
بأثره بالغ السوء على عقلية الفقيه ومجالات اشتغاله، خاصة في القضايا ذات الصلة
بالشأن العام، حيث انحصر دوره في مجالات التعبد الفردي وبعض القضايا مثل الأحوال
الشخصية وبعض المعاملات البنكية التي تجري وَفْقًا لأحكام الشريعة لكن تحت مظلة
النظام المالي التقليدي، وصار الفقيه بحاجة إلى إعادة تأهيل لينخرط في قضايا
المجال العام؛ لأن القلة من الفقهاء مَنْ يصلح لذلك.
2- الانكفاء على الذات وعدم الانخراط في الشأن العام:
وهو فرع عن
الفرع السابق، وقد عمَّق آثاره السلبية التخادم بين الاستعمار والاستبداد،
اللَّذيْنِ عَمِلَا من خلال الوسائل الناعمة والخشنة على إبقاء البلاد الإسلامية
تحت الهيمنة، الأمر الذي أدَّى بدوره إلى إعادة تشكيل دور الفقيه وتموضعه للعمل في
المساحات الآمنة.
3- غياب الوسائل التنفيذية والقدرات التنظيمية:
في ظل هذا
الواقع، لم يعد الفقيه يملك من الأدوات الذاتية ما يؤهله لتوجيه الواقع والتأثير
فيه سياسيًّا واجتماعيًّا على النحو المأمول، وحتى إن وُجدت أدواتٌ مستقلة لدى بعض
رجال الشريعة، فإن وسائل الاحتواء والبطش تترصّدهم من كل جانب.
صحيح أن للفقيه
حضورًا من خلال الأحزاب الإسلامية التي تسعى إلى تغيير الواقع وإصلاحه، لكنّ الأثر
الحقيقي يتطلَّب منه الاقتراب من دوائر صنع القرار أو المشاركة في زمام القيادة؛
وإلا بقي تأثيره محدودًا، غير أن الواقع يُظهِر أن الفقيه صار زاهدًا إلى حدٍّ
بعيدٍ في هذه القضايا، وانكفأ على ذاته ومشاريعه العلمية في أحسن الأحوال.
4- تقليدية الأدوات وأثرها على الفاعلية:
الواقع الذي نشأ
وتطوّر فيه الفقه الإسلامي يختلف جذريًّا عن واقع اليوم الذي يتسم بالتعقيد
والتسارع الشديدَيْنِ؛ وبالتالي فقدت الأدوات التقليدية التي يملكها الفقيه
التقليدي كثيرًا من فاعليتها في مواجهة تحديات العصر.
ختامًا، إن
تجاوز هذا التأخّر يقتضي نشوءَ فقيهٍ مشتَبكٍ لا منعزل، متفاعلٍ مع الواقع
وتفاصيله، فهو وحده القادر على أن يكون فاعلًا فيه ومؤثرًا في مساراته؛ ما يفرض
بدوره ضرورة تجديد الفقه والفقيه معًا، وهو ما يتحدث عنه المقال اللاحق بإذن الله.
اقرأ أيضاً:
- فقه الاستجابة في زمن التحولات (1)
- دور الفقيه الحضاري وقت الأزمات
















