الفصل بين المتعاطفين وحكم غسل الرجلين
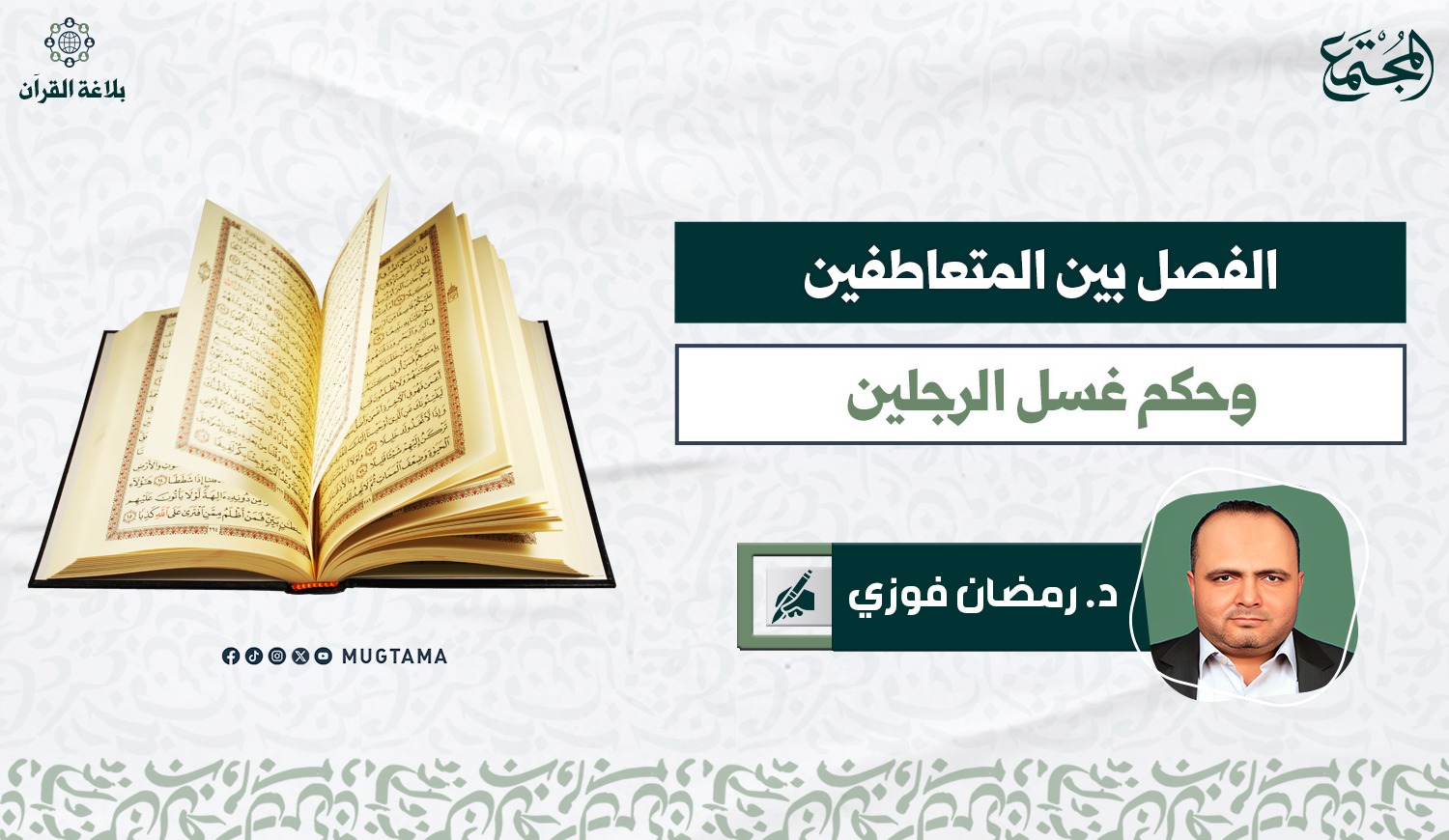
منع بعض النحاة الفصل بين المعطوف
والمعطوف عليه بأجنبي؛ من باب أن التابع والمتبوع ككلمة واحدة، ويرى بعضهم جواز
الفصل مطلقاً، وبعضهم الآخر فصَّل في المسألة؛ فجعل هناك عطفاً واجباً وعطفاً
مستحسناً.
ومن الآيات القرآنية التي تعد من أبرز
شواهد الفصل بين المتعاطفين في القرآن الكريم، على رأي من أجازوا الفصل بينهما،
قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَينِ) (المائدة: 6)؛ حيث يؤثر توجيهها بصورة مباشرة في
استنباط الحكم الفقهي منها في مسألة: هل الواجب غسل الرجلين في الوضوء أم مسحهما؟
فقد قُرئت الآية الكريمة بنصب اللام في «أرجلكم»
وبكسرها، ولكل من القراءتين توجيهاتها المختلفة على النحو التالي:
أولاً: لقراءة النصب توجيهان:
الأول: أنها معطوفة على «وجوهكم»، وقيل:
على «أيديكم»، قال الشافعي: «ونحن نقرؤها «وأرجلَكم» على معنى اغسلوا وجوهكم
وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم.
الثاني: أنه معطوف على موضع «برؤوسكم»،
وهو رأي من اعترضوا على الفصل بين المتعاطفين، (والحكم الفقهي أن القرآن نزل
بالمسح والسُّنة أوجبت الغسل).
ثانياً: قراءة الجر:
أما قراءة الجر فقد اختلفوا في توجيهها؛
حيث ذهب بعضهم إلى أنها مخفوضة على المجاورة، وذهب آخرون إلى أنها معطوفة على «رؤوسكم»
لفظاً فقط، وذهب غيرهم إلى أنها معطوفة على «رؤوسكم» لفظاً ومعنى.
ولكل توجيه من هذه التوجيهات استنباطات
فقهية مختلفة، على النحو التالي:
الأول: الخفض على المجاورة: (وهو فيه أخذ
ورد خاصة في المتعاطفين) لكن القول به يبني عليه فقهياً غسل الأرجل إتْبَاعاً
للوجوه والأيدي.
الثاني: العطف على «رؤوسكم» لفظاً فقط:
مشابهة لقراءة النصب فيكون حكمه الفقهي هو الغسل على التقديم والتأخير؛ كأنه قال:
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين.
الثالث: العطف على «رؤوسكم» لفظاً ومعنى:
ينبني عليه الأحكام التالية:
1- القول بأن حكم الرجلين هو المسح دون
الغسل (وهو رأي الشيعة الإمامية).
2- القول بأن القرآن نزل بمسح الرجلين،
وأن غسلهما وجب بالسُّنة (وهو رأي ابن حزم).
3- أن المقصود هنا هو المسح على الخفين.
4- أن المسح هنا هو الغسل الخفيف؛ حيث
تسمي العرب المسح غسلاً؛ فتقول: «تمسحنا للصلاة».
الإمام الطبري يفك الالتباس
وللإمام ابن جرير الطبري رأي لطيف يجمع
بين قراءتي النصب والجر، نراه يفك الالتباس الناشئ في قراءة الجر؛ حيث يقول: «والصواب
من القول عندنا في ذلك أن الله عزّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء،
كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ، كان
مستحقًّا اسم «ماسح غاسل»؛ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، ومسحهما
إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو «غاسل ماسح».
الترجيح اللغوي
نرى من الناحية اللغوية أنه لا مانع من
الفصل بين المتعاطفين إذا أُمن اللبس موافقة للقائلين به من النحاة، ولتعدد
الشواهد على ذلك في القرآن سواء فُصل بكلمة أم جملة أم حتى جملتين، كما في قوله
تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ
لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ) (المائدة: 5)؛
حيث فصل بين المعطوف «المحصنات» والمعطوف عليه «الطيبات» بجملتين كاملتين مبتدأتين
متعاطفتين وهما (وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ)، و(وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ).
وفائدة الاعتراض بين المتعاطفين في آية
الوضوء –كما أشار الطاهر بن عاشور- الإشارة إلى ترتيب أعضاء الوضوء؛ لأنّ الأصل في
الترتيب الذكري أن يدلّ على التّرتيب الوجودي.
وفي حالة الجر نرى أنها معطوفة على «رؤوسكم»
لفظاً ومعنى، وأن المسح المقصود هنا هو الغسل، أو باعتبار المسح جزءاً من الغسل عن
طريق تدليك الجزء الممسوح باليد أو ما قام مقامها، كما ذكر ابن جرير الطبري في
رأيه السابق، ويكون المتوضئ «ماسحاً غاسلاً».
وربما يكون في المسح والغسل مع الرجل
حكمة، وهي أن مسح الرجل باليد في أثناء الغسل يكون أدعى لإزالة ما بها من أوساخ
مظنونة في الرِّجل لقربها من الأرض، دون الإسراف في استخدام الماء لمظنة الإسراف
معها نتيجة صب الماء عليها صباً دون باقي المغسولات في الوضوء (وقد ألمح إلى مثل
هذا الزمخشري).
كما نرى أن القول بأن القرآن نزل بالمسح
في الرجلين غير دقيق؛ إذ المسح يجزئ منه القليل، كما هي الحال مع الرأس المسبوقة
بباء التبعيض، لكن ذكر «إلى الكعبين» مع الرجل يوحي بأن المقصود هو الغسل إلى
الكعبين كما حدد مع الأيدي إلى المرفقين.
وكذلك، فإن ذكر الكعبين يمنع كون المقصود
هنا المسح على الخفين أو الجوارب كما ذهب إليه بعضهم؛ لأن المسح عليها يجزئ بالمسح
على أعلاهما فقط، ولم يشترط فيها المسح إلى الكعبين، كما روي عن علي رضي الله عنه
أنه قال: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْي لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى
بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» (سنن أبي داود)، والكعبان ليسا في ظاهر القدم
وأعلاه بل في أسفله.
















