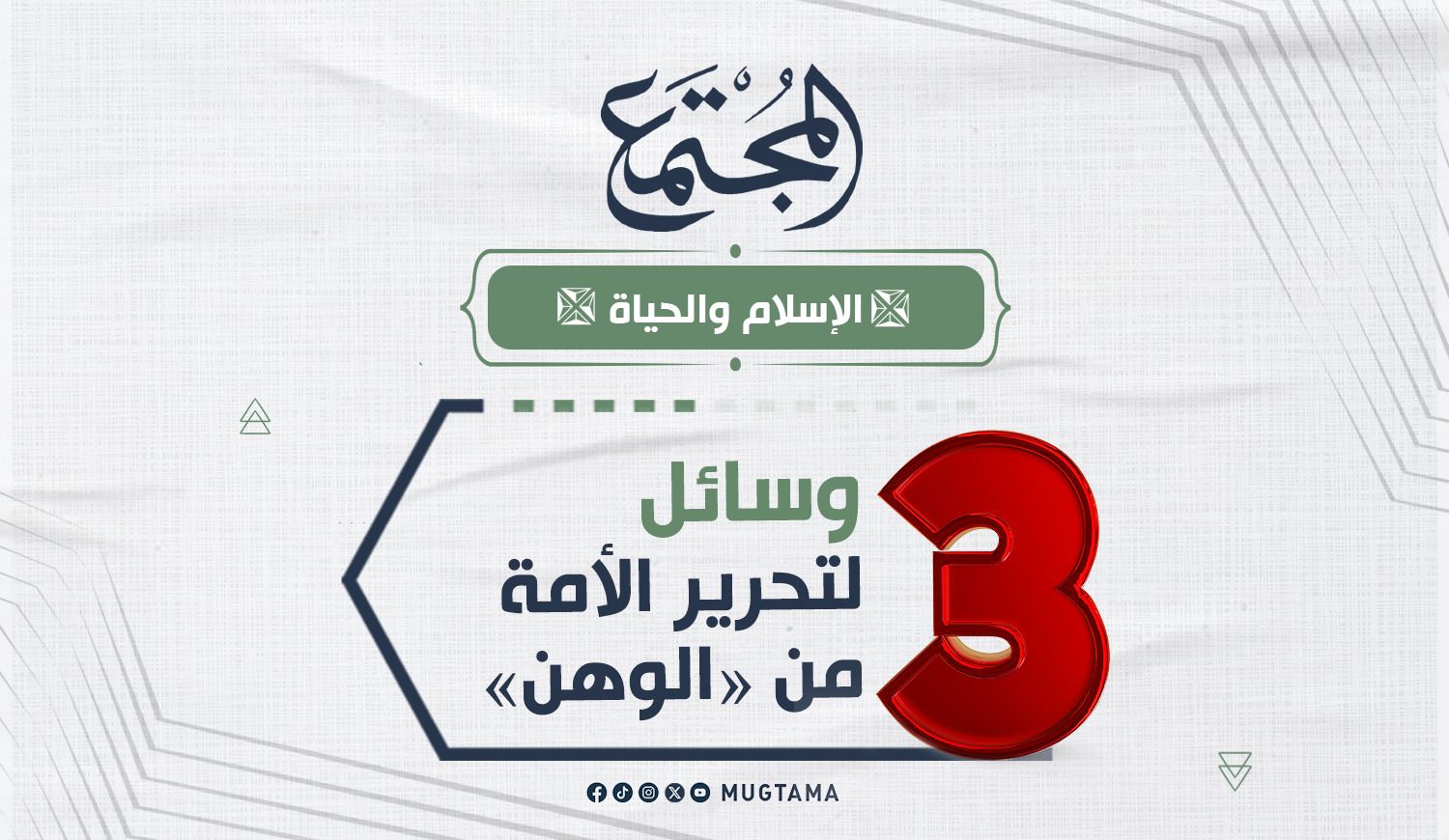غفلة الأقوياء وصمت الضمير.. أسباب العجز تجاه المستضعفين في الإسلام
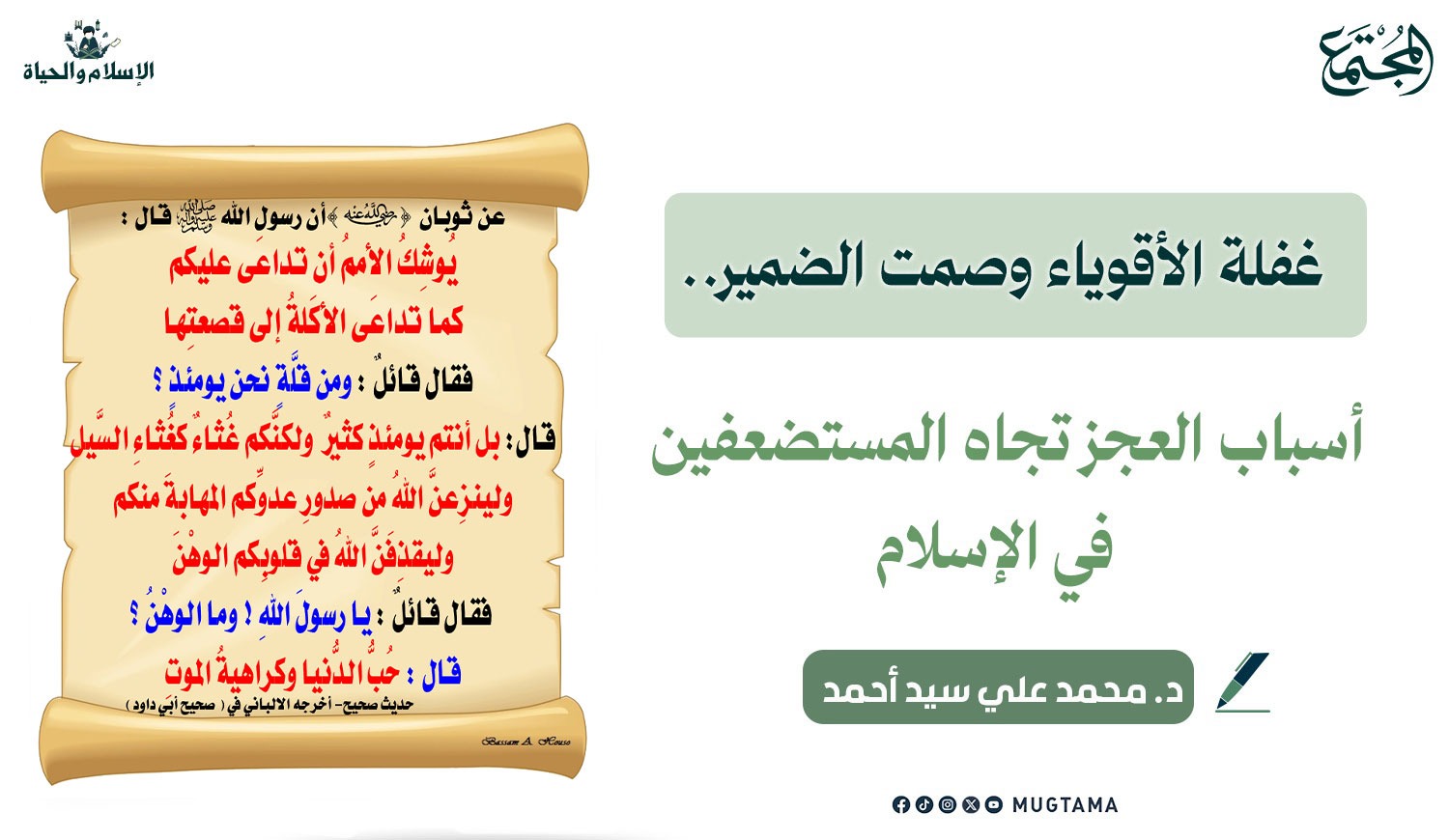
جاء الإسلام دينًا شاملاً للعدالة والرحمة، ونص على وجوب نصرة المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يملكون لأنفسهم حيلة، ومع ذلك، نجد اليوم عجزًا ملحوظًا وتقصيرًا كبيرًا في مناصرة هؤلاء، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول أسباب هذا العجز، التي منها ما يلي.
أولاً: ضعف الإيمان وقلة التوكل:
يجني المسلم إذا ضعف إيمانه بربه واعتمد
على مخلوق سواه، قسوة قلب وابتعاد عن الله تعالى، فلا يعرف بعدها معروفاً ولا ينكر
منكراً، ويزداد جبن قلبه وخوفه من المخلوقين، خوفاً يدفع إلى ترك الواجبات أو فعل
المحرمات، ويتجه نحو الطمع في المخلوقين، ويفزع عند نزول المصيبة، ولا يقدر على
مواجهة الواقع بثبات، كما لا يهتم بقضايا المسلمين، لأن مَن ضعُف إيمانه وقَل
توكله تعلق بالدنيا وشغف بها، وإذا فاتته شعر بالألم عند فوات حظه منها.
فإذا كان هذا على مستوى الفرد، إلا أن خطر ضعف الإيمان على مستوى الأمة أنكى وأشد، فتأخر المسلمين اليوم عن القيادة العالمية لشعوب الأرض لم يكن ظلماً وقعاً بهم، بل كان نتيجة طبيعية لقوم نسوا رسالتهم، وأهملوا السنن الربانية، وظنوا أن التمكين قد يكون بالأماني والأحلام، لكن هيهات، بل هو من صميم العدل الإلهي(1)؛ (ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيۡسَ بِظَلَّامٖ لِّلۡعَبِيدِ) (آل عمران: 182).
والنجاة في العودة إلى الله تعالى وتصديق وعده والأخذ بالأسباب التي تعمل على تحقيق المراد معتمداً على الله فيها دون الاعتماد على الأسباب، فيأتي بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بها، ويتوكل على الله توكل من يرى أنها لا تنجيه، ولا تحصل له فلاحاً، ولا توصله إلى المقصود، فيجرد عزمه للقيام بها حرصاً واجتهاداً، ويفرغ قلبه من الاعتماد عليها، والركون إليها، تجريداً للتوكل، واعتماداً على الله وحده.
وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين
هذين الأصلين، ففي سنن الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «احرص
على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز»؛ فأمره بالحرص على الأسباب، والاستعانة
بالمسبب، ونهاه عن العجز، وهو نوعان: تقصير في الأسباب، وعدم الحرص عليها، وتقصير
في الاستعانة بالله وترك تجريدها، فالدين كله ظاهره وباطنه، شرائعه وحقائقه تحت
هذه الكلمات النبوية(2).
ثانياً: حب الدنيا والخوف
من فقدان المصالح:
حين يأنس المسلم بالدنيا يجعلها لنفسه
مقراً، ويثقل عليه مفارقتها، همه فيها إشباع رغبته وتحقيق شهوته فلا يشغله مسلم
مستضعف ولا مؤمن مستباح عرضه، غاية مراده مصالح شخصية، ولا يفكر في الموت، فحب
الدنيا والخوف على فقدان المصالح الشخصية يقوّي ضغط الأعداء ويفرق جمع المسلمين.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته
من ذلك، فعند أبي داود عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُوشِك
الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»، فقال قائل: ومن قلة نحن
يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور
عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوَهْن»، فقال قائل: يا رسول الله،
وما الوَهْن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت».
ودواء هذا الداء في إخراج حب الدنيا من القلب، ومعرفة قيمة نصرة المسلمين المستضعفين في الأرض وعظيم ثواب الله تعالى الذي أعده لمثل هؤلاء، فالفضيل بن عياض يقول: لو كانت الدنيا ذهباً يفنى والآخرة خزفاً يبقى لكان ينبغي أن تؤثر خزفاً يبقى على ذهب يفنى، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟!(3).
ثالثاً: الفرقة بين المسلمين:
أدت الفرقة بين المسلمين إلى الخلاف
والنزاع وعرّضتهم إلى الشقاق والعداوة، وأوقعتهم في الشتات والأهواء، وأنشأت بينهم
الخصومة والعصبية، وفتحت الباب على مصراعيه لتمكن الأعداء منهم.
فأمة تفرق شملها وضعف قواها وعبث العدو
بها لا يمكن لها أن تساند المستضعفين أو تنصر المظلومين أو ترفع الأذى عن
المضرورين أو تدفع الخطر عن المكلومين، أمة في حاجة إلى معالجة نفسها قبل أن تفكر
في مساندة المستضعفين من أبناء أمتها، وعدوها يرفع شعار «فرق تسد».
فالفرقة تعَالَج بالتوحد، والعداوة تعالج
بالمحبة، وطرق الشيطان تعالج باتباع سبل الرحمن، فالمسلمون إن لم يجمعهم الحق شعّبهم
الباطل، وإن لم توحدهم عبادة الرحمن مزقتهم عبادة الشيطان، وإن لم يستهوهم نعيم
الآخرة تخاصموا على متاع الدنيا، ولذلك كان التطاحن المر من خصيصة الجاهلية
المظلمة وديدن من لا إيمان لهم(4).
رابعاً: الوهن:
معناه الضعف من حيث الخَلْق والخُلُق(5)،
والوهن بمعنى الضّعف الخَلْقِيّ أمر طبعيّ لا يتعلّق به مدح أو ذمّ، وأما الوهن الخُلُقِيّ المصحوب بالتّخاذل
والخوف من لقاء الأعداء والجبن عن منازلتهم فهو منهيّ عنه بنصّ الآية الكريمة: (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (آل عمران: 139)؛ أي
لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محمّد عن جهاد أعدائكم لما أصابكم(6).
وقد أخبر الله تعالى عن الأتباع
الحقيقيّين للرّسل الّذين جاهدوا معهم فأصابوا وأصيبوا، فلم يفتّ في عضدهم ما
أصابهم في سبيل الله وما لحقهم وهن ولا ضعف ولا استكانة، وهكذا ينبغي أن يكون شأن
المؤمنين في كلّ زمان ومكان، قال تعالى: (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما
وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكانُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) (آل عمران: 146).
إلا أن وهن المسلمين وضعفهم أدى إلى أخطار
جمة على المستضعفين منهم، أبرزها ضياع الهوية الإسلامية، وفقدان الهيبة في قلوب
الأعداء، وانتشار الانهزامية النفسية، والرضا بالظلم، وانتشار الفساد، والتنازل عن
المبادئ الدينية من مساعدة المستضعفين ونصرتهم.
ومعالجة هذا الوهن إنما يكون بيقين أن ما
أصاب المسلمين من الألم قد أصاب الأعداء مثله، إلا أنّ المسلمين يتمتّعون بقوّة
إيمانهم ونبل مسلكهم وانتظار الظّفر أو الجنّة، كما أنّ المسلمين هم الأعلون بنصرة
الله لهم لأنّه حليفهم وناصرهم، ومن كان الله معه فكيف يخاف من عواقب معركة مهما
كانت؛ (فَلا تَهِنُوا
وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ
يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ) (محمد: 35).
فالعجز عن نصرة المستضعفين ليس مجرد
تقصير، بل هو خيانة لأمانة الإسلام، وغفلة عن مبدأ عظيم من مبادئه، وقد آن الأوان
أن يفيق المسلمون من هذا السبات، ويتحملوا مسؤوليتهم الشرعية والأخلاقية تجاه
إخوانهم.
______________________
(1) الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، محمد
الغزالي، ص147.
(2) مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية،
ج3، ص464.
(3) مكاشفة القلوب، أبو حامد الغزالي،
ص127.
(4) خلق المسلم، محمد الغزالي، 165.
(5) بصائر ذوي التمييز، الفيروز أبادي (5/
287).
(6) الجامع لأحكام القرآن الكريم، الإمام
القرطبي (4/ 230).